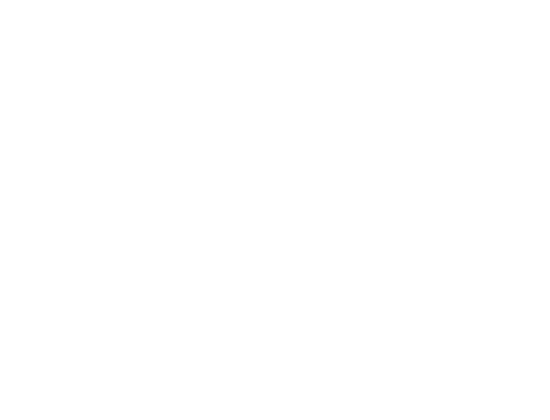{بسم
الله الرحمن الرحيم} البسملة تقدم الكلام عليها، {الرحمـن* علم القرءان*
خلق الإنسان* علمه البيان} {الرحمـن } مبتدأ، وجملة {علم القرءان } خبر،
{خلق الإنسان } خبر ثان، {علمه البيان } خبر ثالث، والمعنى أن هذا الرب
العظيم، الذي سمى نفسه بالرحمن تفضل على عباده بهذه النعم، والرحمن هو ذو
الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، كما قال تعالى: {ورحمتي وسعت كل شيء}.
وابتدأ هذه السورة بالرحمن عنواناً على أن ما بعده كله من رحمة الله تعالى،
ومن نعمه {علم القرءان } أي: علمه من شاء من عباده، فعلمه جبريل عليه
السلام أولاً، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثانياً،
ثم بلغه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثالثاً إلى جميع الناس، والقرآن
هو هذا الكتاب العزيز الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية، كما قال الله
تعالى: {إنا جعلناه قرءاناً عربياً لعلكم تعقلون } وقـال تعالـى: {نزل به
الروح الأَمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان
عربي مبين} وتعليم القرآن يشمل تعليم لفظه، وتعليم معناه، وتعليم كيف
العمل به، فهو يشمل ثلاثة أشياء، {خلق الإنسان } المراد الجنس، فيشمل آدم
وذريته، أي: أوجده من العـدم، فالإنسـان كان معدوماً قبل وجوده، وقبل خلقه،
قال الله - عز وجل -: {هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً
مذكوراً} يعني أتى عليه حين من الدهر قبل أن يوجد، وليس شيئاً مذكوراً ولا
يعلم عنه، وبدأ الله تعالى بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان إشارة إلى أن
نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ من نعمته بخلق الإنسان وإلا فمن
المعلوم أن خلق الإنسان سابق على تعليم القرآن، لكن لما كان تعليم القرآن
أعظم منة من الله - عز وجل - على العبد قدمه على خلقه {علمه} أي: علم
الإنسان {البيان }، أي: ما يبين به عما في قلبه، وأيضاً ما يستبين به عند
المخاطبة، فهنا بيانان: البيان الأول من المتكلم، والبيان الثاني من
المخاطب، فالبيان من المتكلم يعني التعبير عما في قلبه، ويكون باللسان
نطقاً، ويكون بالبنان كتابة، فعندما يكون في قلبك شيء تريد أن تخبر به،
تارة تخبر به بالنطق، وتارة بالكتابة، كلاهما داخل في قوله {علمه البيان }،
وأيضاً {علمه البيان } كيف يستبين الشيء وذلك بالنسبة للمخاطب يعلم ويعرف
وما يقول صاحبه، ولو شاء الله تعالى لأسمع المخاطب الصوت دون أن يفهم
المعنى فالبيان سواء من المتكلم، أو من المخاطب كلاهما منة من الله - عز
وجل - فهذه ثلاث نعم: {علم القرءان خلق الإنسان علمه البيان}.
{الشمس
والقمر بحسبان} لما تكلم عن العالم السفلي بين العالم العلوي فقال: {الشمس
والقمر بحسبان}أي: بحساب دقيق معلوم متقن منتظم أشد الانتظام، يجريان كما
أمرهما الله - عز وجل - ولم تتغير الشمس والقمر منذ خلقهما الله عز وجل إلى
أن يفنيهما يسيران على خط واحد، كما أمرهما الله، وهذا دليل على كمال قدرة
الله تعالى، وكمال سلطانه، وكمال علمه أن تكون هذه الأجرام العظيمة تسير
سيراً منظماً، لا تتغير على مدى السنين الطوال، {والنجم والشجر يسجدان }
النجم اسم جنس، والمراد به النجوم تسجد لله - عز وجل - فهذه النجوم العليا
التي نشاهدها في السماء تسجد لله - عز وجل - سجوداً حقيقياً، لكننا لا نعلم
كيفيته، لأن هذا من الأمور التي لا تدركها العقول، والشجر يسجد لله عز وجل
سجوداً حقيقياً، لكن لا ندري كيف ذلك، والله على كل شيء قدير، وانظر إلى
الأشجار إذا طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس تشاهدها بعينك، وكلما
ارتفعت، ارتفعت الأشجار، وإذا مالت للغروب مالت، لكن هذا ليس هو السجود،
إنما السجود حقيقة لا يُعلم، كما قال - عز وجل -: {تسبح له السماوات السبع
والأَرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولـكن لا تفقهون تسبيحهم إنه
كان حليمًا غفورًا } فالنجوم كلها تسجد لله، والأشجار كلها تسجد لله - عز
وجل - قال الله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في
الأَرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس}
ويقابله،{وكثير حق عليه العذاب} فلا يسجد - والعياذ بالله - {والسماء
رفعها} يعني ورفع السماء ولم يحدد في القرآن الكريم مقدار هذا الرفع، لكن
جاءت السنة بذلك، فهي رفيعة عظيمة ارتفاعاً عظيماً شاهقاً، {ووضع الميزان }
أي: وضع العدل، والدليل على أن المراد بالميزان هنا العدل قوله تعالى:
{لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان} يعني العدل،
وليس المراد بالميزان هنا الميزان ذا الكفتين المعروف ولكن المراد بالميزان
العدل، ومعنى وضع الميزان أي أثبته للناس، ليقوموا بالقسط أي بالعدل {ألا
تطغوا في الميزان } يعني ألا تطغوا في العدل، يعني وضع العدل لئلا تطغوا في
العدل فتجوروا، فتحكم للشخص وهو لا يستحق، أو على الشخص وهو لا يستحق،
{وأقيموا الوزن بالقسط } ، يعني وزنكم للأشياء،
أقيموه ولا تبخسوه فتنقصوا، لهذا قال: {ولا تخسروا الميزان } أي لا تخسروا
الموزون، فصار الميزان يختلف في مواضعه الثلاثة: {ووضع الميزان } أي: العدل
{ألا تطغوا في الميزان } لا تجوروا في الوزن {ولا تخسروا الميزان } أي:
الموزون.
{والأَرض
وضعها للأَنام } يعني: أن من نعم الله - عز وجل - أن الله وضع الأرض
للأنام أي: أنزلها بالنسبة للسماء، والأنام هم الخلق، ففيها الإنس، وفيها
الجن، وفيها الملائكة، تنزل بأمر الله - عز وجل - من السماء، وإن كان مقر
الملائكة في السماء لكن ينزلون إلى الأرض، مثل الملكين اللذين عن اليمين
وعن الشمال قعيد، والملائكة الذين يحفظون من أمر الله المعقبات، والملائكة
الذين ينزلون في ليلة القدر وغير ذلك، {فيها}، أي في الأرض {فاكهة} أي:
ثمار يتفكه بها الناس، وأنواع الفاكهة كثيرة، كالعنب والرمان والتفاح
والبرتقال وغيرها {والنخل ذات الأَكمام } نص على النخل، لأن ثمرتها أفضل
الثمار فهي حلوى وغذاء وفاكهة، وشجرتها من أبرك الأشجار وأنفعها، حتى إن
النبي صلى الله عليه وسلم شبه النخلة بالمؤمن فقال: «إن من الشجر شجرة
مثلها مثل المؤمن»، فخاض الصحابة - رضي الله عنهم - في
الشجر حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها النخلة (1)
وقوله: {ذات الأَكمام } جمع كم وهو غلاف الثمرة، فإن ثمرة النخل أول ما
تخرج يكون عليها كم قوي، ثم تنمو في ذلك الكم حتى يتفطر وتخرج الثمرة،
{والحب ذو العصف} الحب يعني الذي يؤكل من الحنطة والذرة والدخن والأرز وغير
ذلك، وقوله: {ذو العصف} يعني ما يحصل من ساقه عند يبسه وهو ما يعرف
بالتبن؛ لأنه يعصف أي تطؤه البهائم بأقدامها حتى ينعصف، {والريحان } هذا
الشجر ذو الرائحة الطيبة، فذكر الله في الأرض الفواكه، والنخل، والحب،
والريحان، لأن كل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص به، وكل ذلك من أجل
مصلحة العباد ومنفعتهم {فبأي ءالآء ربكما تكذبان } الخطاب للجن والإنس،
والاستفهام للإنكار، أي: أي نعمة تكذبون بها {خلق الإنسان من صلصال كالفخار
} خلق الإنسان يعني جنسه من صلصال، والصلصال هو الطين اليابس الذي له صوت،
عندما تنقره بظفرك يكون له صوت كالفخار، هو الطين المشوي، وهذا باعتبار
خلق آدم عليه السلام، فإن الله خلقه من تراب، من طين، من صلصال كالفخار، من
حمأ مسنون، كل هذه أوصاف للتراب ينتقل من كونه تراباً، إلى كونه طيناً،
إلى كونه حمأ، إلى كونه صلصالاً، إلى كونه كالفخار، حتى إذا استتم نفخ الله
فيه من روحه فصار آدمياً، {وخلق الجآن} وهم الجن {من مارج من نار }،
المارج هو المختلط الذي يكون في اللهب إذا ارتفع صار مختلطاً بالدخان،
فيكون له لون بين الحمرة والصفرة، فهذا هو المارج من نار، والجان، خلق قبل
الإنس، ولهذا قال إبليس لله - عز وجل -: {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته
من طين } {فبأي ءالآء ربكما تكذبان } أي: بأي نعمة من نعم الله تكذبون،
حيث خلق الله - عز وجل - الإنسان من هذه المادة، والجن من هذه المادة،
وأيهما خير التراب أم النار؟ التراب خير، لا شك فيه، ومن أراد أن يطلع على
ذلك فليرجع إلى كلام ابن القيم - رحمه الله - في كتاب «إغاثة اللهفان من
مكائد الشيطان» {رب المشرقين ورب المغربين } يعني هو رب، فهي خبر
مبتدأ محذوف، والتقدير: هو رب المشرقين ورب المغربين، يعني أنه مالكهما
ومدبرهما، فما من شيء يشرق إلا بإذن الله، ولا يغرب إلا بإذن الله وما من
شيء يحوزه المشرق والمغرب إلا لله - عز وجل - وثنى المشرق هنا باعتبار مشرق
الشتاء ومشرق الصيف، فالشمس في الشتاء تشرق من أقصى الجنوب، وفي الصيف
بالعكس، والقمر في الشهر الواحد يشرق من أقصى الجنوب ومن أقصى الشمال، وفي
آية أخرى قال الله تعالى: {فلا أقسم برب المشارق والمغارب} فجمعها، وفي آية
ثالثة {رب المشرق والمغرب لا إلـه إلا هو فاتخذه وكيلاً } فما الجمع
بينها؟ نقول: أما التثنية فباعتبار مشرقي الشتاء والصيف،أما جمع المغارب
والمشارق فباعتبار مشرق كل يوم ومغربه، لأن الشمس كل يوم تشرق من غير
المكان الذي أشرقت منه بالأمس، فالشمس يتغير شروقها وغروبها كل يوم،
ولاسيما عند تساوي الليل والنهار، فتجد الفرق دقيقة، أو دقيقة ونصفاً بين
غروبها بالأمس واليوم، وكذلك الغروب، أو باعتبار الشارقات والغاربات، لأنها
تشمل الشمس والقمر والنجوم، وهذه لا يحصيها إلا الله - عز وجل -، أما
قوله: {رب المشرق والمغرب} فباعتبار الناحية، لأن النواحي أربع: مشرق، ومغرب، وشمال، وجنوب، {فبأي ءالآء ربكما تكذبان } أي: بأي شيء من
نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ فما جوابنا على هذه الاستفهامات
بهذه الآيات كلها؟ جوابنا: ألا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا، ولهذا ورد حديث
في إسناده ضعف عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه
وسلم على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا،
فقال: «لقد قرأتها على الجن، ليلة الجن، فكانوا أحسن مردوداً منكم، كنت
كلما أتيت على قوله{فبأي ءالآء ربكما تكذبان } قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا
نكذب، فلك الحمد». لكن هذا الحديث ضعيف (2) ،
يذكره المفسرون هنا، وكل آية أعقبت {فبأي ءالآء ربكما تكذبان } فهي تتضمن
نعماً عظيمة، فما النعم التي يتضمنها اختلاف المشرق والمغرب؟ النعم ما
يترتب على ذلك من مصالح الخلق: صيفاً، وشتاء، ربيعاً، وخريفاً، وغير ذلك
مما لا نعلم، فهي نعم عظيمة باختلاف المشرق والمغرب، ثم قال سبحانه وتعالى:
{مرج البحرين يلتقيان } مرج بمعنى أرسل البحرين، يعني المالح والعذب
{يلتقيان }، يلتقي بعضهما ببعض، البحر المالح هذه البحار العظيمة، البحر
الأحمر، والبحر الأبيض، والبحر الأطلسي، وهذه البحار كلها مالحة، وجعلها
الله تبارك وتعالى مالحة، لأنها لو كانت عذبة لفسد الهواء وأنتنت، لكن
الملح يمنع الإنتان والفساد، والبحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار التي
تأتي: إما من كثرة الأمطار، وإما من ثلوج تذوب وتسيح في الأرض، فالله
سبحانه وتعالى أرسلهما بحكمته وقدرته حيث شاء - عز وجل - {يلتقيان } أي:
يلتقي بعضهما ببعض عند مصب النهر في البحر فيمتزج بعضهما ببعض، لكن حين
سيرهما أو حين انفرادهما، يقول الله - عز وجل -: {بينهما برزخ} وهو اليابس
من الأرض {لا يبغيان } أي: لا يبغي أحدهما على الآخر، ولو شاء الله تعالى لسلط
البحار ولفاضت على الأرض وأغرقت الأرض، لأن البحر عندما تقف على الساحل لا
تجد جداراً يمنع انسيابه إلى اليابس مع أن الأرض كروية، ومع ذلك لا يسيح
البحر لا هاهنا، ولا هاهنا بقدرة الله عز وجل، ولو شاء الله - سبحانه
وتعالى - لساحت مياه البحر على اليابس من الأرض ودمرتها، إذن البرزخ الذي
بينهما هو اليابس من الأرض هذا قول علماء الجغرافيا، وقال بعض أهل العلم:
بل البرزخ أمر معنوي يحول بين المالح والعذب أن يختلط بعضهما ببعض، وقالوا:
إنه يوجد الآن في عمق البحار عيون عذبة تنبع من الأرض، حتى إن الغواصين
يغوصون إليها ويشربون منها كأعذب ماء، ومع ذلك لا تفسدها مياه البحار، فإذا
ثبت ذلك فلا مانع من أن نقول بقول علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير،
والله على كل شيء قدير {فبأي ءالآء ربكما تكذبان يخرج
منهما اللؤلؤ والمرجان} أي: يخرج من البحرين العذب والمالح اللؤلؤ
والمرجان، وهو قطع من اللؤلؤ أحمر جميل الشكل واللون مع أنها مياه، وقوله
تعالى: {منهما} أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح، وقد قيل: إن اللؤلؤ
لا يخرج إلا من المالح ولا يخرج من العذب، والذين قالوا بهذا اضطربوا في
معنى الآية، كيف يقول الله {منهما} وهو من أحدهما؟ فأجابوا: بأن
هذا من باب التغليب، والتغليب أن يغلب أحد الجانبين على الآخر، مثلما
يقال: العمران، لأبي بكر وعمر، ويقال: القمران، للشمس والقمر، فهذا من باب
التغليب، فـ {منهما} المراد واحد منهما، وقال بعضهم: بل هذا على حذف مضاف،
والتقدير: يخرج: من أحدهما، وهناك قول ثالث: أن
تبقى الآية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف، ويقول {منهما} أي: منهما جميعاً
يخرج اللؤلؤ والمرجان، وإن امتاز المالح بأنه أكثر وأطيب.
فبأي
هذه الأقوال الثلاثة، نأخذ؟ نأخذ بما يوافق ظاهر القرآن، فالله - عز وجل -
يقول: {يخرج منهما} وهو خالقهما وهو يعلم ماذا يخرج منهما، فإذا كانت
الآية ظاهرها أن اللؤلؤ يخرج منهما جميعاً وجب الأخذ بظاهرها، لكن لا شك أن
اللؤلؤ من الماء المالح أكثر وأطيب، لكن لا يمنع أن نقول بظاهر الآية، بل
يتعين أن نقول بظاهر الآية، وهذه قاعدة في القرآن والسنة: إننا نحمل الشيء
على ظاهره، ولا نؤول، اللهم إلا لضرورة، فإذا كان هناك ضرورة، فلابد أن
نتمشى على ما تقتضيه الضرورة، أما بغير ضرورة فيجب أن نحمل القرآن والسنة
على ظاهرهما {فبأي ءالاء ربكما تكذبان } لأن ما في هذه البحار وما يحصل من
المنافع العظيمة، نِعم كثيرة لا يمكن للإنسان أن ينكرها أبداً.
{وله
الجوار المنشئات في البحر كالأَعلام } أي لله - عز وجل - ملكاً وتدبيراً
وتيسيراً {الجوار} بحذف الياء للتخفيف، وأصلها الجواري جمع جارية، وهي
السفينة تجري في البحر كما قال الله - عز وجل -: {ألم تر أن الفلك تجرى في
البحر بنعمت الله} {المنشئات} أي: التي أنشأها صانعوها ليسيروا عليها في
البحر، وقوله: {في البحر} متعلق بالجواري أي الجواري في البحر، وليست فيما
يظهر متعلقة بالمنشآت، يعني الجواري التي تصنع في البحر، لأن السفن تصنع في
البر أولاً، ثم تنزل في البحر، وقوله: {كالأَعلام } تشبيه، والأعلام جمع
علم وهو الجبل، كما قال الشاعر:
وإن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار
كأنه
جبل، ومن شاهد السفن في البحار رأى أن هذا التشبيه منطبق تماماً عليها،
فهي كالجبال تسير في البحر بأمر الله - عز وجل -، وإنما نص الله عليها
لأنها تحمل الأرزاق من جانب إلى جانب، ولولا أن الله تعالى يسرها لكان في
ذلك فوات خير كثير للبلاد التي تنقل منها والبلاد التي تنقل إليها، وفي هذا
العصر جعل الله تبارك وتعالى جواري أخرى، لكنها تجري في الجو، كما تجري
هذه في البحر، وهي الطائرات، فهي منة من الله - عز وجل - كمنته على عباده
في جواري البحار، بل ربما نقول: إن السيارات أيضاً من جواري البر، فتكون
الجواري ثلاثة أصناف: بحرية، وبرية، وجوية، وكلها من نعم الله - عز وجل -،
ولهذا قال: {فبأي ءالآء ربكما تكذبان } أي بأي: نعمة من نعم الله تكذبان،
والخطاب للإنس والجن، ثم قال - عز وجل -: {كل من عليها} أي: كل من على
الأرض {فان } أي: ذاهب من الجن والإنس والحيوان والأشجار، قال الله تبارك
وتعالى: {إنا جعلنا ما على الأَرض زينةً لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً} أي: خالية، وقال الله تعالى: {ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها
قاعاً صفصفاً} أي: يذر الأرض قاعاً صفصفاً، أو يذر الجبال بعد أن كانت
عالية شامخة قاعاً كالقيعان مساوية لغيرها، صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا
أمتاً، {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام } أي: يبقى الله - عز وجل - ذو
الوجه الكريم، وكان بعض السلف إذا قرأ هاتين الآيتين وصل بعضهما ببعض، قال:
ليتبين بذلك كمال الخالق ونقص المخلوق (3) ؛ لأن المخلوق فانٍ والرب باقٍ،
وهذه الملاحظة جيدة أن تصل فتقول: {كل من عليها فان ويبقى
وجه ربك ذو الجلال والإكرام} وهذا هو محط الثناء والحمد على الله - عز وجل
- أن تفنى الخلائق ويبقى الله - عز وجل - وقوله تعالى: {ويبقى وجه ربك ذو
الجلال والإكرام } فيه إثبات الوجه لله - سبحانه وتعالى - ولكنه وجه لا
يشبه أوجه المخلوقين، لقوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير }
يعني أنت تؤمن بأن لله وجهاً، لكن يجب أن تؤمن بأنه لا يماثل أوجه
المخلوقين بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع
البصير } ولما ظن بعض أهل التعطيل أن إثبات الوجه يستلزم التمثيل أنكروا أن
يكون لله وقالوا: المراد بقوله {ويبقى وجه ربك} أي ثوابه، أو أن كلمة
{وجه} زائدة، وأن المعنى: ويبقى ربك! ولكنهم ضلوا سواء السبيل، وخرجوا عن
ظاهر القرآن وحرفوه وخرجوا عن طريق السلف الصالح، ونحن نقول: إن لله وجهاً،
لإثباته له في هذه الآية، ولا يماثل أوجه المخلوقين لنفي المماثلة في
قوله: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } وبذلك نسلم ونجري النصوص على
ظاهرها، المراد بها، وقوله: {ذو الجلال} أي: ذو العظمة {والإكرام } أي:
إكرام من يطيع الله - عز وجل - كما قال تعالى: {أولـئك في جنات مكرمون }
فالإكرام أي أنه يكرم من يستحق الإكرام من خلقه، ويحتمل أن يكون لها معنى
آخر وهو أنه يُكْرَم من أهل العبادة من خلقه، فيكون الإكرام هذا المصدر
صالحاً للمفعول والفاعل، فهو مكرَم ومكرِم {فبأي ءالآء ربكما تكذبان} وهذه
الآية تكررت عدة مرات في هذه السورة، ومعناها أنه بأي نعمة من نعم الله
تكذبان يا معشر الجن والإنس، وهذا كالتحدي لهم، لأنه لن يستطيع أحد أن يأتي
بمثل هذه النعم، ثم قال سبحانه وتعالى: {يسأله من في السموات والأَرض كل
يوم هو في شأن } أي: يسأل الله من في السماوات والأرض، والذي في السماوات
هم الملائكة يسألون الله - عز وجل - ومن سؤالهم أنهم {ويستغفرون للذين
آمنوا ربنا وسعت كـل شيء رحمةً وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك
وقهم عذاب الجحيم } إلى آخره، ويسأله من في الأرض من الخلائق، وسؤال أهل
الأرض لله - عز وجل - قسمان: الأول: السؤال بلسان المقال، وهذا إنما يكون
من المؤمنين، فالمؤمن يسأل ربه دائماً حاجاته، لأنه يعلم أنه لا يقضيها إلا
الله - عز وجل - وسؤال المؤمن ربه عبادة، سواء حصل مقصوده أم لم يحصل،
فإذا قلت: يا رب أعطني كذا. فهذه عبادة، كما جاء في الحديث: «الدعاء عبادة
(4) ». وقال تعالى {وقال ربكـم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين } فقال {ادعوني} ثم
قال: {إن الذين يستكبرون عن عبادتي} وهذا دليل على أن الدعاء عبادة، النوع
الثاني: دعاء بلسان الحال، وهو أن كل مخلوق مفتقر إلى الله ينظر إلى رحمته،
فالكفار مثلاً ينظرون إلى الغيث النازل من السماء، وإلى نبات الأرض، وإلى
صحة الحيوان، وإلى كثرة الأرزاق وهم يعلمون إنهم لا يستطيعون أن يجدوا ذلك
بأنفسهم، فهم إذن يسألون الله بلسان الحال، ولذلك إذا مستهم ضراء اضطروا
إلى سؤال الله بلسان المقال {وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له
الدين}. {كل يوم هو في شأن } من يحصي الأيام؟ لا أحد إلا الله - عز وجل -
ومن يحصي الشهور؟ لا أحد إلا الله - عز وجل - {كل يوم هو في شأن }، يغني
فقيراً، ويفقر غنيًّا، ويمرض صحيحاً، ويشفي سقيماً، ويؤمّن خائفاً ويخوف
آمناً، وهلم جرا، كل يوم يفعل الله تعالى ذلك، هذه الشئون التي تتبدل عن
حكمة ولا شك، قال الله تعالى: {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا
ترجعون } وقال تعالى: {أيحسب الإنسان أن يترك سدًى } فنحن نؤمن أن الله لا
يقدر قدراً إلا لحكمة، لكن قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلم، ولهذا قال: {كل
يوم هو في شأن }، ولكن اعلم أيها المؤمن أن الله تعالى لا يقدر لك قدراً
إلا كان خيراً لك، إن أصابتك ضراء فاصبر وانتظر الفرج، وقل: الحمد لله على
كل حال. وكما يقال: دوام الحال من المحال، فينتظر الفرج فيكون خيراً له،
وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن {فبأي ءالآء
ربكما تكذبان } نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة أن المعنى بأي نعمة من
نعم الله تكذبان؟ والجواب: لا نكذب بشيء من نعم الله، بل نقول: هي من عند
الله، فله الحمد وله الشكر، ومن نسب النعمة إلى غير الله فهو مكذب. وإن لم
يقل إنه مكذب قال الله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون } وهذه الآية
يعني بها قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
وهو يحدث أصحابه على إثر مطر كان، قال لهم بعد صلاة الصبح: «هل تدرون ماذا
قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي
وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب،
وأما من قال: مطرنا بنوء كذا، وكذا، فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب» (5) .
{سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي
ءالآء ربكما تكذبان} هذه الجملة المقصود بها الوعيد، كما يقول قائل لمن
يتوعده سأتفرغ لك، وأجازيك. وليس المعنى أن الله تعالى يشغله شأن عن شأن ثم
يفرغ من هذا، ويأتي إلى هذا، هو سبحانه يدبر كل شيء في آن واحد في مشارق
الأرض ومغاربها وفي السماوات، وفي كل مكان يدبره في آن واحد، ولا يعجزه.
فلا تتوهمن أن قوله: {سنفرغ} أنه الآن مشغول وسيفرغ. بل هذه جملة وعيدية
تعبر بها العرب، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب وفي قوله: {سنفرغ لكم} من
التعظيم ما هو ظاهر حيث أتى بضمير الجمع، {سنفرغ} تعظيماً لنفسه - جل وعلا -
وإلا فهو واحد، وقوله: {أيها الثقلان } يعني الجن والإنس، وإنما وجه هذا
الوعيد إليهما، لأنهما مناط التكليف، {فبأي ءالآء ربكما تكذبان } سبق
تفسيرها فلا حاجة إلى التكرار {يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا
من أقطار السموات والأَرض فانفذوا} بعد الوعيد قال: {إن استطعتم أن تنفذوا}
أي: مما نريده بكم {من أقطـر السموات والأَرض
فانفذوا} ولكنكم لا تستطيعون هذا، فالأمر هنا للتعجيز، ولهذا قال: {لا
تنفذون إلا بسلطان } يعني ولا سلطان لكم، ولا يمكن أحد أن ينفذ من أقطار
السماوات والأرض إلى أين يذهب؟ لا يمكن ثم قال: {فبأي ءالآء ربكما تكذبان يرسل
عليكما شواظ من نار} يعني لو استطعتم، أو لو حاولتم لكان هذا الجزاء {يرسل
عليكما شواظ من نار ونحاس} أي: محمى بالنار {فلا تنتصران} أي: فلا ينصر
بعضكم بعضاً، وهذه الآية في مقام التحدي، وقد أخطأ غاية الخطأ من زعم أنها
تشير إلى ما توصل إليه العلماء من الطيران، حتى يخرجوا من أقطار الأرض ومن
جاذبيتها، وإلى أن يصلوا كما يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمر، فالآية
ظاهرة في التحدي، والتحدي هو توجيه الخطاب إلى من لا يستطيع، ثم نقول: إن
هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات، لو فرضنا أنهم نفذوا من
أقطار الأرض ما نفذوا من أقطار السماوات، فالآية واضحة أنها في مقام
التحدي، وأنها لا تشير إلى ما زعم هؤلاء أنها تشير إليه، ونحن نقول الشيء
الواقع لا نكذبه، ولكن لا يلزم من تصديقه أن يكون القرآن دل عليه أو السنة،
الواقع واقع، فهم خرجوا من أقطار الأرض، وهذا واقع لا يحتاج إلى دليل،
وهذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامة، لأنه
قال: {كل من عليها فان }، ثم ذكر {يسأله من في السماوات والأَرض} ثم ذكر
{يا معشر الجن}، ثم ذكر ما بعدها يوم القيامة، {فإذا انشقت السماء} يعني
تفتحت وذلك يوم القيامة، كما قال تعالى: {إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت أيها
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه} {فكانت وردةً} أي: مثل الوردة في
الحمرة {كالدهان }، كالجلد المدهون، {فبأي ءالآء ربكما تكذبان } {فيومئذ}
أي: إذا انشقت {لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جآن } لماذا؟ لأن كل شيء معلوم،
والمراد لا يسأل سؤال استرشاد واستعلام، لأن كل شيء معلوم، أما سؤال تبكيت
فيسأل مثل قوله تعالى: {ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأَنبـاء يومئذ فهم لا يتساءلون} وقال - عز وجل -: {إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا
لم نك من المصلين} وقال - عز وجل - لأهل النار وهم يلقون فيها: {أولم تك
تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى} وأمثالها كثير، إذن لا يسأل عن ذنبه سؤال
استرشاد واستعلام، وإنما يسألون سؤال تبكيت وتوبيخ، وما جاء من سؤال الإنس
والجن عن ذنوبهم: هل أنت عملت أو لم تعمل؟ فهو سؤال تبكيت وتوبيخ، وهناك
فرق بين سؤال الاسترشاد وسؤال التوبيخ فلا تتناقض الآيات، فما جاء أنهم
يسألون فهو سؤال توبيخ، وما جاء أنهم لا يسألون فهو سؤال استرشاد واستعلام،
لأن الكل معلوم ومكتوب، {فبأي ءالآء ربكما تكذبان يعرف
المجرمون بسيماهم} أي: بعلامتهم يعرفون، ومن علاماتهم - والعياذ بالله -
أنهم سود الوجوه، قال الله تعالى: {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه} وأنهم يحشرون
يوم القيامة زرقاً إما أنهم زرق أحياناً وسود أحياناً، وإما أنهم سود
الوجوه زرق العيون، وإما أنهم زرق زرقة يعني بالغة يحسبها الإنسان سوداء
{يعرف المجرمون بسيمـهم فيؤخذ بالنواصي والأَقدام } النواصي مقدم الرأس،
والأقدام معروفة، فتؤخذ رجله إلى ناصيته، هكذا يطوى طيًّا إهانة له وخزياً
له، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ويلقون في النار {فبأي ءالآء ربكما تكذبان هـذه
جهنم التى يكذب بها المجرمون} يعني يقال هذه جهنم التي تكذبون بها، وقال
{المجرمون } ولم يقل: تكذبون بها، إشارة إلى أنهم مجرمون، وما أعظم جرم
الكفار الذين كفروا بالله ورسوله، واستهزؤا بآيات الله واتخذوها هزواً
ولعباً، {يطوفون بينها} أي: يترددون بينها {وبين حميم ءان } أي: شديد
الحرارة - والعياذ بالله -. أما كيف يكون ذلك فالله أعلم، لكننا نؤمن بأنهم
يطوفون بينها وبين الحميم الحار الشديد الحرارة، والله أعلم بذلك، {فبأي
ءالآء ربكما تكذبان }، ثم ذكر جزاء أهل الجنة فقال: {ولمن خاف مقام ربه
جنتان } يعني أن من خاف المقام بين يدي الله يوم القيامة، فإن له جنتين.
وهذا الخوف يستلزم شيئين: الشيء الأول: الإيمان بلقاء الله - عز وجل - لأن
الإنسان لا يخاف من شيء إلا وقد تيقنه. والثاني: أن يتجنب محارم الله، وأن
يقوم بما أوجبه الله خوفاً من عقاب الله تعالى، فعليه يلزم كل إنسان أن
يؤمن بلقاء الله - عز وجل -، لقوله تعالى: {يا أيها الإنسان إنك كادح إلى
ربك كدحاً فملاقيه } وقال تعالى: {واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر
المؤمنين}، وأن يقوم بما أوجبه الله، وأن يجتنب محارم الله فمن خاف هذا
المقام بين يدي الله - عز وجل - فله جنتان {فبأي ءالآء ربكما تكذبان } سبق
الكلام عليها {ذواتآ أفنان} أي صاحبتا أفنان، والأفنان جمع فنن وهو الغصن،
أي أنهما مشتملتان على أشجار عظيمة ذواتي أغصان كثيرة وهذه الأغصان كلها
تبهج الناظرين {فبأي ءالآء ربكما تكذبان }، ثم قال {فيهما عينان تجريان }
أي: في الجنتين عينان تجريان، وقد ذكر الله تعالى أن في الجنة أنهاراً من
أربعة أصناف، فقال - جل وعلا -: {مثل الجنة التى وعد المتقون فيهآ أنهار من
ماء غير ءاسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من عسل مصفى} والعينان اللتان تجريان، يظهر - والله أعلم - أنهما
سوى هذه الأنهار الأربعة{فبأي ءالآء ربكما تكذبان } وقوله: {فيهما من كل
فاكهة زوجان } أي: في هاتين الجنتين من كل فاكهة،والفاكهة كل ما يتفكه
الإنسان به مذاقاً ونظراً، فيشمل أنواع الفاكهة الموجودة في الدنيا، وربما
يكون هناك فواكه أخرى ليس لها نظير في الدنيا، {فبأي ءالآء ربكما تكذبان }
{متكئين على فرش بطآئنها من إستبرق وجنى الجنتين دان } أي: يتنعمون
بهذه الفاكهة حال كونهم متكئين، وعلى هذا فكلمة متكئين حال من فاعل والفعل
المحذوف، أي: يتنعمون ويتفكهون، متكئين، والاتكاء قيل: إنه التربع، لأن
الإنسان أريح ما يكون إذا كان متربعاً، وقيل {متكئين} أي: معتمدين على
مساند من اليمين والشمال ووراء الظهر {على فرش} يعني جالسين {على فرش
بطآئنها من إستبرق} يعني بطانة الفراش وهو ما يدحى به الفراش من استبرق وهو
غليظ الديباج، وأما أعلى هذه الفرش فهو من سندس، وهو رقيق الديباج، وكله
من الحرير {وجنى الجنتين دان } تأمل أو تصور هذه الحال إنسان متكىء مطمئن
مستريح يريد أن يتفكه من هذه الفواكه هل يقوم من مكانه الذي هو مستقر فيه
متكىء فيه ليتناول الثمرة؟ بيّن الله بقوله تعالى ذلك {وجنى الجنتين دان }
قال أهل العلم: إنه كلما نظر إلى ثمرة وهو يشتهيها، مال الغصن حتى كانت
الثمرة بين يديه لا يحتاج إلى تعب وإلى قيام، بل هو متكىء، ينظر إلى الثمرة
مشتهياً إياها، فتتدلى له بأمر الله - عز وجل - مع أنها جماد، لكن الله
تعالى أعطاها إحساساً بأن تتدلى عليه إذا اشتهاها ولا تستغرب فهاهي الأشجار
في الغالب تستقبل الشمس، انظر إلى وجوه الأوراق أول النهار تجدها متجهة
إلى المشرق، وفي آخر النهار تجدها متجهة إلى المغرب ففيها إحساس، كذلك
أيضاً جنى الجنتين دان قريب يحس، إذا نظر إليه الرجل أو المرأة فإنه يتدلى
حتى يكون بين يديه، {فبأي ءالآء ربكما تكذبان فيهن
قاصرات الطرف} {فيهن} أكثر العلماء يقولون: إن الضمير يعود إلى الجنتين،
وأن الجمع باعتبار أن لكل واحد من الناس جنة خاصة به، فيكون {فيهن} أي في
جنة كل واحد ممن هو في هاتين الجنتين قاصرات الطرف، وعندي أن قوله {فيهن}
يشمل الجنات الأربع، هاتين الجنتين، والجنتين اللتين بعدهما، {قاصرات
الطرف} يعني أنها تقصر طرفها أي نظرها على زوجها فلا تريد غيره، والوجه
الآخر: قاصرات الطرف، أي: أنها تقصر طرف زوجها عليها فلا يريد غيرها، وعلى
القول الأول يكون قاصرات مضافة إلى الفاعل، وعلى الثاني مضاف إلى المفعول
{لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جآن } أي: لم يجامعهن، وقيل: إن الطمث مجامعة
البكر، والمعنى أنهن أبكار لم يجامعهن أحد من قبل لا إنس ولا جن، وفي هذا
دليل واضح على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، {فبأي ءالآء ربكما تكذبان كأنهن
الياقوت والمرجان} أي: في الحسن والصفاء كالياقوت والمرجان، وهما جوهران
نفيسان، الياقوت في الصفاء، والمرجان في الحمرة، يعني أنهن مشربات بالحمرة
مع صفاء تام {فبأي ءالآء ربكما تكذبان }، ثم قال - عز وجل -: {هل جزاء
الإحسان إلا الإحسان } يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، الإحسان الأول:
العمل، والإحسان الثاني: الثواب، أي: ما جزاء إحسان العمل إلا إحسان
الثواب، {فبأي ءالآء ربكما تكذبان ومن دونهما
جنتان} أي: من دون الجنتين السابقتين جنتان من نوع آخر، وقد جاء ذلك مبيناً
في السنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : «جنتان من ذهب آنيتهما، وما
فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما (6) » والآية صريحة أن هاتين
الجنتين دون الأوليان {فبأي ءالآء ربكما تكذبان مدهآمتان} أي: سوداوان من كثرة الأشجار {فبأي ءالآء ربكما تكذبان فيهما
عينان نضاختان} أي: تنضخ بالماء، أي: تنبع، وفي الجنتين السابقتين قال:
{فيهما عينان تجريان }، والجري أكمل من النبع، لأن النبع لايزال في مكانه
لكنه لا ينضب، أما الذي يجري فإنه يسيح، فهو أعلى وأكمل، {فبأي ءالآء ربكما
تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان } وهناك يقول:
{فيهما من كل فاكهة زوجان }، أما هذا فقال {فيهما فاكهة ونخل ورمان }،
والنخل والرمان معروفان في الدنيا، ولكن يجب أن تعلم أنه لا يستوي هذا
وهذا. الاسم واحد والمسمى يختلف اختلافاً كثيراً، ودليل ذلك قوله
تعالى: {فلا تعلم نفس مآ أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون }
ولو كانت النخل والرمان كالنخل والرمان في الدنيا لكنا نعلم، لكننا لا
نعلم، فالاسم واحد، ولكن الحقيقة مختلفة، ولهذا قال ابن عباس - رضي الله
عنهما -: «ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط» (7) ، {فبأي ءالآء
ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان} {فيهن} وهذا جمع،
وقد قال قبل ذلك {فيهما}، لأن هذا الجمع يعود على الجنان الأربع، ففي
الجنان الأربع قاصرات الطرف كما سبق، وفي الجنان الأربع {خيرات حسان } أي:
في الأخلاق. الأخلاق طيبة، حسان الوجوه والبدن، فالأول حسن الباطن وهذا حسن
الظاهر {فبأي ءالآء ربكما تكذبان * حور مقصورات في الخيام} الحوراء هي
الجميلة، التي جملت في جميع خلقها، وبالأخص العين: شديدة البياض، شديدة
السواد، واسعة مستديرة من أحسن ما يكون، {مقصورات} أي: مخبئات، {في الخيام
}: جمع خيمة، والخيمة معروفة هي بناء له عمود وأروقة، لكن الخيمة في الآخرة
ليست كالخيمة في الدنيا، بل هي خيمة من لؤلؤة طولها في السماء مرتفع جداً،
ويرى من في باطنها من ظاهرها، ولا تسأل عن حسنها وجمالها، هؤلاء الحور
مقصورات مخبئات في هذه الخيام على أكمل ما يكون من الدلال والتنعيم {لم
يطمثهن إنس قبلهم ولا جآن } يعني لم يجامعهن أحد، بل هي باقية على بكارتها
إلى أن يغشاها زوجها، جعلنا الله منهم، {ولا جآن } أي: ولا جن، وهذا يدل
على أن الجن يدخلون الجنة مع الإنس وهو كذلك، لأن الله لا يظلم أحداً،
والجن منهم صالحون، ومنهم دون ذلك، ومنهم مسلمون ومنهم كافرون، كالإنس
تماماً، كما أن الإنس فيهم مطيع وعاصٍ، وفيهم كافر ومؤمن، كذلك الجن، والجن
المسلم فيه خير، ويدل على الخير، وينبىء بالخير، ويساعد أهل الصلاح من
الإنس، والجن الفاسق أو الكافر مثل الفاسق أوالكافر من بني آدم سواء بسواء،
وكافرهم يدخل النار ، بإجماع المسلمين كما في القرآن: {قال ادخلوا في أمم
قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار} وهذا نص القرآن، وأجمع العلماء
على أن الكافر من الجن يدخل النار، ومؤمن الجن يدخل الجنة، وقوله تعالى:
{لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جآن } يدل على أن الجن يدخلون الجنة، وهو كذلك
{فبأي ءالآء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر
وعبقري حسان} أي: معتمدين بأيديهم وظهورهم {على رفرف} أي: على مساند ترفرف
مثل ما يكون على أطراف المساند، ويكون في الأسرّة، هكذا يرفرف، {متكئين على
رفرف خضر}، لأن اللون الأخضر أنسب ما يكون للنظر، وأشد ما يكون بهجة
للقلب، {وعبقري حسان }، العبقري هو الفرش الجيدة جداً، ولهذا يسمى الجيد من
كل شيء عبقري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية التي رآها حين
نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «فما رأيت عبقرياً يفري فريه» (8) أي:
ينزع نزعه: من قوته رضي الله عنه، {فبأي ءالآء ربكما تكذبان } المعنى
التقرير، يعني أن النعم واضحة فبأي شيء تكذبون؟ الجواب: لا نكذب بشيء،
نعترف بآلاء الله ونعمه ونقر بها ونعترف بأننا مقصرون، لم نشكر الله تعالى
حق شكره، ولكننا نؤمن بأن الله أوسع من ذنوبنا، وأن الله تبارك وتعالى عفو
كريم يحب توبة عبده، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، حتى قال النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم» وذكر الرجل
في فلاة أضل راحلته، وعليها طعامه وشرابه، فطلبها ولم يجدها، فأيس منها
فاضطجع في ظل شجرة ينتظرالموت، آيس من الحياة، فإذا بخطام ناقته متعلقاً
بالشجرة، فأخذه وقال:«اللهم أنت عبدي وأنا ربك» (9) ، يريد أنت ربي وأنا
عبدك، لكن من شدة الفرح أخطأ فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»، فالله تعالى
أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته، اللهم تب علينا يا رب العالمين
{تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام } ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة
بهذه الجملة العظيمة، أي ما أعظم بركة الله - عز
وجل - وما أعظم البركة باسمه، حتى إن اسم الله يحلل الذبيحة أو يحرمها، لو
ذبح الإنسان ذبيحة ولم يقل باسم الله تكون ميتة حراماً نجسة مضرة على
البدن، حتى لو ذبح ونسي أن يقول: بسم الله. فهي حرام نجسة تفسد البدن، فيجب
أن يسحبها للكلاب، لأنها نجسة، قال الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر
اسم الله عليه وإنه لفسق} فانظر البركة، والإنسان إذا توضأ ولم يسم فوضوؤه
عند بعض العلماء فاسد لابد من الإعادة، لأن البسملة واجبة عند بعض أهل
العلم، والإنسان إذا رأى الصيد الزاحف، أو الطائر فيرميه ولم يسمِ يكون هذا
الصيد حراماً ميتة نجساً مضراً على البدن، فانظر البركة، والإنسان إذا أتى
أهله يعني جامع زوجته وقال: «بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان
ما رزقتنا» كان هذا حماية لهذا الولد الذي ينشأ من هذا الجماع، حماية له من
الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال:
«بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن يقدر
بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً (10) » والإنسان يسعى يميناً وشمالاً
لحماية ولده ويخسر الدراهم الكثيرة، وهنا هذا الدواء من الرسول عليه الصلاة
والسلام وهو يسير من ناحية العمل، وسهل، وكل هذا دليل على بركة اسم الله
عز وجل، {ذي الجلال والإكرام } أي: ذي العظمة والإكرام،{ذي الجلال والإكرام
}: بمعنى صاحب، وهي صفة لرب، لا لـ(اسم) ولو كانت صفة لـ(اسم) لكانت ذو،
والإكرام يعني هو يُكرِم وهو يُكرَم، فهو يكرم ويحترم ويعظم - عز وجل - وهو
أيضاً يكرم، قال الله تعالى في أصحاب الجنة {أولـئك في جنات مكرمون } فهو
ذو الجلال والإكرام يكرم من يستحق الإكرام، وهو يكرمه - عز وجل - عباده
الصالحون جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.
واستودعكم الله التي لآ تضيع ودائعةة ~~.